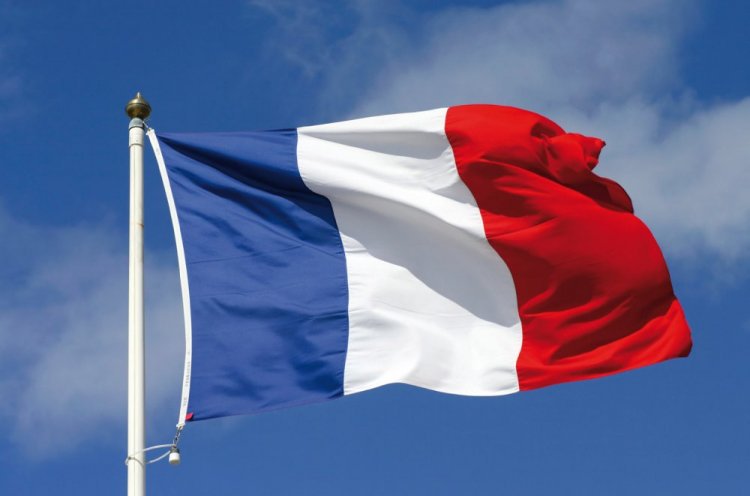
السفير 24 – جمال اشبابي – باريس
يبدو أن مصلحة الإحصاء في “بلاس بوفو” (وزارة الداخلية الفرنسية) قد قررت التخلي عن لغة الخشب لتعتمد لغة الأرقام الصارخة، تاركة للخبراء مادة دسمة لثرثرة المساء. في فرنسا، نتعامل مع أرقام الهجرة كما نتعامل مع النشرة الجوية؛ نفتح المظلات حين تشتد العاصفة، ثم ننسى الأمر بمجرد ظهور أول شعاع شمس سياسي. لكن رياح هذا العام تحمل معها تفاصيل لا تخطئها العين، تفصل بين جاليتين في سباق محموم نحو بطائق الإقامة الفرنسية، إذ لم يعد الرهان مجرد أعداد، بل “بروفايلات” تقاس بالمسطرة والقلم.
فمن جانب، نجد الجالية المغربية التي يبدو أنها فهمت “كتالوج” المطالب الفرنسية الجديدة قبل الجميع. لم يعد المهاجر المغربي يأتي ليملأ فراغا في المصانع، بل ليحجز مقعدا في مدرجات الهندسة والطب. مع أكثر من 36 ألف بطاقة إقامة أولى، يتفوق المغربي بذكاء، مانحا لفرنسا مادة رمادية جاهزة للاستعمال، تتحدث لغة موليير بطلاقة وتجتاز اختبارات قيم الجمهورية الفرنسية بابتسامة الواثق. إنها هجرة “الاستثمار” التي يحبها اليمين واليسار على حد سواء: يدخلون بصمت، يعملون بكد، ويدفعون ضرائبهم دون إثارة جلبة حول الهوية.
في الزاوية المقابلة، ما تزال الجزائر تراهن على “الرصيد التاريخي” وعقود عام 1968 المتلاشية. بينما يملأ المغاربة استمارات الجامعات، يملأ الجزائريون استمارات “التجمع العائلي”. ومع نحو 30 ألف بطاقة إقامة أولى تمنح سنويا، يبقى الجزائري في مستوى عددي قريب. هنا، لا نتحدث عن مشروع اقتصادي، بل عن “امتداد اجتماعي” يجر خلفه ثقل الذاكرة الاستعمارية وأوجاعها.
المشكلة ليست في عدد القادمين، بل في طبيعة الوصول إلى فرنسا؛ فبينما يدخل المغربي بـ “سيرة ذاتية” متينة، يدخل الجزائري بـ “شجرة عائلة” تطالب بحقوق تاريخية لم تعد مكاتب الهجرة في باريس تعترف بصرفها في سوق اليوم.
وزير الداخلية، الذي ينام وعيناه على أرقام (OQTF) -أوامر مغادرة التراب الفرنسي- يجد في الجزائر صداعا مزمنا. فالأرقام لا تكذب، والجزائريون يتصدرون قوائم المغادرين “نظريا”، في حين يظهر المغرب كشريك “براغماتي” يعرف كيف يستعيد مواطنيه حين تطلب باريس ذلك، بينما تكتفي الجزائر بالوقوف عند أطلال الماضي، متسائلة لماذا لم يعد “جواز السفر الأخضر الجزائري” يفتح الأبواب كما كان يفعل في زمن الرفيق ميتيران.
هذه الأرقام تحولت إلى “هدايا عيد ميلاد” لجوردان بارديلا وأعضاء حزبه في “التجمع الوطني” (يمين متطرف). بالنسبة لهؤلاء، لا فرق بين مهندس مغربي يبرمج الخوارزميات وبين حالم جزائري وصل لتوه؛ فالهوية الفرنسية عندهم مهددة دائما، والإحصائيات ليست سوى عد تنازلي “لنهاية فرنسا”، حتى لو كان القادمون الجدد يتقنون لغة موليير أكثر من بعض نواب اليمين أنفسهم.
ومع دخول قوانين يناير 2026 حيز التنفيذ، بمتطلباتها اللغوية التي تشبه اختبارات دخول “السوربون”، سيجد الكثيرون أنفسهم خارج اللعبة. فرنسا لم تعد تبحث عن مهاجرين، بل عن “موظفين بامتيازات محدودة”. الفرز القادم سيكون قاسيا؛ فبين من يملك اللغة والشهادة (النموذج المغربي) ومن يملك الحنين والقرابة (النموذج الجزائري)، حسمت باريس خيارها. في “جمهورية الكفاءات” الجديدة، لم يعد يكفي أن تحب فرنسا، بل يجب أن تثبت لها أنك “مربح” اقتصاديا.





